
[b]أبو فهر" محمود محمد شاكر[/b]
[b] 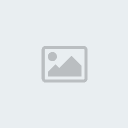
[/b]
ظاهرة فريدة في الأدب والثقافة العربية الحديثة، فهو كاتب له طريقته
الخاصة لا تبارى أو تحاكى، وشاعر مبدع حقق في الإبداع الشعري ما بلغ ذروته
في قصيدته "القوس العذراء"، ومحقق بارع لكتب التراث، قادر على فك رموزها
وقراءة طلاسمها، ومفكر متوهج العقل ينقض أعتى المسلمات، ومثقف واسع الاطلاع
في صدره أطراف الثقافة العربية كلها فكانت عنده كتابا واحدا.
غير أن
العلامة الشيخ محمود محمد شاكر ظل سنوات طويلة في عزلة اختارها لنفسه، يقرأ
ويدرس ويصدح في واحته الظليلة، لا يسمع غناءه إلا المقربون منه من تلامذته
ومحبيه تاركا الدنيا ببريقها وأضوائها وراء ظهره، ولم يخرج من واحته إلا
شاكي السلاح مستجيبا لدعوة الحق حين يشعر بأن ثقافة أمته يتهددها الخطر،
فيقصم بقلمه الباتر زيف الباطل، ويكشف عورات الجهلاء المستترين وراء
الألقاب الخادعة؛ ولذلك جاءت معظم مؤلفاته استجابة لتحديات شكلت خطرا على
الثقافة العربية.
البداية والتكوين ينتمي
محمود شاكر إلى أسرة أبي علياء من أشراف جرجا بصعيد مصر، وينتهي نسبه إلى
الحسين بن علي رضي الله عنه، وقد نشأ في بيت علم، فأبوه كان شيخا لعلماء
الإسكندرية وتولى منصب وكيل الأزهر لمدة خمس سنوات (1909-1913م)، واشتغل
بالعمل الوطني وكان من خطباء ثورة 1919م، وأخوه العلامة أحمد شاكر واحد من
كبار محدثي العصر، وله مؤلفات وتحقيقات مشهورة ومتداولة.
انصرف محمود
شاكر -وهو أصغر إخوته- إلى التعليم المدني، فالتحق بالمدارس الابتدائية
والثانوية، وكان شغوفا بتعلم الإنجليزية والرياضيات، ثم تعلق بدراسة الأدب
وقراءة عيونه، وحفظ وهو فتى صغير ديوان المتنبي كاملا، وحضر دروس الأدب
التي كان يلقيها الشيخ المرصفي في جامع السلطان برقوق، وقرأ عليه في بيته:
الكامل للمبرد، والحماسة لأبي تمام.
المواجهة الخافتة وربما
كان في وسع شاكر أن يكون أحد علماء الرياضيات أو فروع الطبيعة بعد حصوله
على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) من القسم العلمي سنة 1925 لكنه فضل
أن يدرس العربية في كلية الآداب، وكاد قانون الجامعة أن يحول بينه وبين
الالتحاق بقسم اللغة العربية، لولا تدخل طه حسين لدى أحمد لطفي السيد مدير
الجامعة وإقناعه بأن يلتحق شاكر بكلية الآداب فأصدر قرارا بذلك.
وفي
الجامعة استمع شاكر لمحاضرات طه حسين عن الشعر الجاهلي وهى التي عرفت بكتاب
"في الشعر الجاهلي"، وكم كانت صدمته حين ادعى طه حسين أن الشعر الجاهلي
منتحل وأنه كذب ملفق لم يقله أمثال امرئ القيس وزهير، وإنما ابتدعه الرواة
في العصر الإسلامي، وضاعف من شدة هذه الصدمة أن ما سمعه من المحاضر الكبير
سبق له أن قرأه بحذافيره في مجلة استشراقية بقلم المستشرق الإنجليزي
مرجليوث.
وتتابعت المحاضرات حول هذا الموضوع، ومحمود شاكر عاجز عن
مواجهة طه حسين بما في صدره، وتمنعه الهيبة والأدب أن يقف مناقشا أستاذه،
وظل على ذلك زمنا لا يستطيع أن يتكلم حتى إذا لم يعد في الصبر والتحمل
بقية، وقف يرد على طه حسين في صراحة وبغير مداراة، لكنه لم يستطع أن يواجهه
بأن ما يقوله إنما هو سطو على أفكار مرجليوث بلا حياء أو اكتراث.
وتولد
عن شعوره بالعجز عن مواجهة التحدي خيبة أمل كبيرة فترك الجامعة غير آسف
عليها وهو في السنة الثانية، ولم تفلح المحاولات التي بذلها أساتذته وأهله
في إقناعه بالرجوع، وسافر إلى الحجاز سنة 1928 مهاجرا، وأنشأ هناك مدرسة
ابتدائية عمل مديرا لها، حتى استدعاه والده الشيخ فعاد إلى القاهرة.
اكتشاف المتنبي وبعد
عودته سنة 1929 انصرف إلى قراءة الأدب ومطالعة دواوين شعراء العربية على
اختلاف عصورهم حتى صارت له ملكة في تذوق الشعر والتفرقة بين نظمه وأساليبه،
وبدأ ينشر بعض قصائده الرومانسية في مجلتي "الفتح" و"الزهراء" لمحب الدين
الخطيب، واتصل بأعلام عصره من أمثال أحمد تيمور وأحمد زكي باشا والخضر حسين
ومصطفى صادق الرافعي الذي ارتبط بصداقة خاصة معه. ولم يكن شاكر معروفا بين
الناس قبل تأليفه كتابه "المتنبي" الذي أثار ضجة كبيرة بمنهجه المبتكر
وأسلوبه الجديد في البحث، وهو يعد علامة فارقة في الدرس الأدبي نقلته من
الثرثرة المسترخية إلى البحث الجاد.
والعجيب أن شاكر الذي ألف هذا
الكتاب سنة 1936 ولم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره لم يكن يقصد تأليف
كتاب عن المتنبي، إنما كان مكلفا من قبل فؤاد صروف رئيس تحرير مجلة المقتطف
بأن يكتب دراسة عن المتنبي مسهبة بعض الإسهاب ما بين عشرين إلى ثلاثين
صفحة، ولكن هذا التكليف تحول على يد شاكر كتابا مستقلا عن المتنبي أنجزه في
فترة زمنية قصيرة على نحو غير مسبوق ونشرته مجلة المقتطف في عددها الصادر
في السادس من شوال 1354هـ الأول من يناير 1936م، وصدر فؤاد صروف مجلته
بقوله: هذا العدد من المقتطف يختلف عن كل عدد صادر منذ سنتين إلى يومنا
هذا، فهو في موضوع واحد ولكاتب واحد.
وقد اهتدى شاكر في كتابه إلى
أشياء كثيرة لم يكتبها أحد من قبله استنتجها من خلال تذوقه لشعر المتنبي،
فقال بعلوية المتنبي وأنه ليس ولد أحد السقائين بالكوفة كما قيل، بل كان
علويا نشأ بالكوفة وتعلم مع الأشراف في مكاتب العلم، وقال بأن المتنبي كان
يحب خولة أخت سيف الدين الحمداني واستشهد على ذلك من شعر المتنبي نفسه، وتم
استقبال الكتاب بترحاب شديد وكتب عنه الرافعي مقالة رائعة أثنى عليه وعلى
مؤلفه.
وكان هذا الكتاب فتحا جديدا في الدرس الأدبي وتحديا لأدباء
العصر، فكتب بعده عبد الوهاب عزام كتابه "المتنبي في ألف عام"، وطه حسين
"مع المتنبي"، واتهمهما شاكر بأنهما احتذيا منهجه، وسطوا على بعض آرائه،
وهاجم شاكر ما كتبه طه حسين في سلسلة مقالات بلغت 12 مقالا في جريدة البلاغ
تحت عنوان "بيني وبين طه حسين".
العالم الإسلامي في بيت شاكر كانت
فترة الخمسينيات فترة مشهودة في حياة شاكر، فقد ترسخت مكانته العلمية وعرف
الناس قدره، وبدأت أجيال من الدارسين للأدب من أماكن مختلفة من العالم
الإسلامي يفدون إلى بيته، يأخذون عنه ويفيدون من علمه ومكتبته الحافلة، من
أمثال: ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، وشاكر الفحام، وإبراهيم شبوح، فضلا
عن كثير من أعلام الفكر الذي كانوا يحرصون على حضور ندوته الأسبوعية كل يوم
جمعة عقب صلاة المغرب، مثل فتحي رضوان ويحيى حقي، ومحمود حسن إسماعيل،
ومالك بن نبي، وأحمد حسن الباقوري، وعلال الفاسي، وعبد الرحمن بدوي، وعبد
الله الطيب.
وشهدت هذه الندوة الدروس الأسبوعية التي كان يلقيها شاكر
على الحاضرين في شرح القصائد الشعرية التي تضمنها كتاب الأصمعيات، وقد
انتفع بهذه الدروس كثيرون، وكان الأديب الكبير يحيى حقي يعلن في كل مناسبة
أن شاكر هو أستاذه الذي علمه العربية وأوقفه على بلاغتها، وأن ترجمات كتب
مالك بن نبي خرجت من بيت شاكر، فقد قام أحد أفراد ندوته وترجمها إلى
العربية وهو الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين، وكان آنذاك شابا صغيرا في
بداية مشواره العلمي.
وفي ندواته الفكرية في بيته كان يعارض عبد الناصر
علانية ويسخر من رجالات الثورة، ويستنكر ما يحدث للأبرياء في السجون من
تعذيب وإيذاء وكان يفعل ذلك أمام زواره ومن بينهم من يشغل منصب الوزارة،
كالشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف آنذاك، ونتيجة لذلك لم يسلم شاكر من
بطش السلطة، فألقت القبض عليه سنة 1959م، وبقي رهن السجن 9 أشهر حتى تدخلت
شخصيات عربية، فأفرج عنه وعاد لمواصلة نشاطه في تحقيق كتاب تفسير الطبري
الذي بدأ في نشره من قبل، وانتظمت ندوته مرة أخرى.
أباطيل وأسمار وظل
شاكر في عزلته الاختيارية بين كتبه وتلاميذه ومحبيه، لا يشارك في الساحة
الفكرية بمقالاته وآرائه حتى بدأ لويس عوض في نشر سلسلة مقالات له في جريدة
الأهرام سنة 1964م، تحت عنوان "على هامش الغفران" وكان الكاتب قد لمع نجمه
بعد تعيينه مستشارا ثقافيا لجريدة الأهرام، وأصبح مهيمنا على أمور الثقافة
في مصر وصار له حواريون وسدنة يبشرون بآرائه.
وقد أثارت مقالات لويس
عوض موجة من الشغب بين أوساط كثير من المثقفين لما فيها من تحامل على الشيخ
المعري، ولم يجرؤ أحد على الرد سوى محمود شاكر الذي خرج من عزلته، وانبرى
للويس عوض في سلسلة من المقالات المبهرة في مجلة الرسالة، كشفت عما في
مقالات لويس عوض من الوهم والخلط التاريخي والتحريف في الاستشهاد بشعر أبي
العلاء المعري، وعدم تمحيص الروايات التاريخية، والادعاء بتلقي المعري علوم
اليونان على يد أحد الرهبان. وكانت مقالات شاكر التي ظهرت تباعا حدثا
ثقافيا مدويا كشفت عن علم غزير ومعرفة واسعة بالشعر وغيره من الثقافة
العربية، وقدرة باهرة على المحاجاة والبرهان، ولم تقف هذه المقالات التي
بلغت ثلاثا وعشرين مقالة عند حدود الرد على كلام لويس عوض، بل انتقلت إلى
الحديث عن الثقافة والفكر في العالم العربي والإسلامي، وما طرأ عليها من
غزو فكري ولا سيما حركة التبشير التي غزت العالم الإسلامي.
وتدخل
الناقد الكبير محمد مندور عند شاكر ليوقف مقالاته دون جدوى، وأصاب لويس عوض
الذعر والهلع من مقالات شاكر التي فضحته بين أوساط المثقفين، وكشفت عن ضعف
ثقافته حتى في تخصصه في الأدب الإنجليزي حين كشف شاكر عن فساد ترجمته
العربية لمسرحية الضفادع لأرسطوفان، وراح لويس عوض يطوف على المجلات والصحف
يستنصرهم ضد شاكر ويزعم أن المعركة بينهما معركة دينية، ولم يتوقف شاكر
عند كتابة مقالاته حتى أغلقت مجلة الرسالة نفسها، وألقي به في غياهب السجن
سنتين وأربعة أشهر من آخر شهر أغسطس سنة 1965م، حتى آخر شهر ديسمبر سنة
1967م، وقد جمعت هذه المقالات في كتابه "أباطيل وأسمار" الذي يعد من أهم
الكتب التي ظهرت في المكتبة العربية في النصف الأخير من القرن العشرين.
معارك فكرية أخرى وبعد
خروجه من السجن هذه المرة عاد إلى ما كان عليه من قبل، فكتب في مجلة
"المجلة" 7 مقالات إضافية تحت عنوان "نمط صعب، نمط مخيف" استجابة لصديقه
الأديب يحيى حقي، حين أشاد بترجمة الشاعر الألماني "جوته" لقصيدة من قصائد
الشاعر الجاهلي "تأبط شرا" وتساءل حول الترتيب الذي اقترحه الشاعر الألماني
حين ترجم القصيدة إلى الألمانية، وحول الشعر القديم وروايته وافتقاد
القصيدة العربية إلى الوحدة، وقد اقتضت الإجابة حول هذه الأسئلة تشعبا في
الكلام، وامتدادا في أطرافه بلغ 400 صفحة حين جمع المقالات في كتاب، وقد
تخلل ذلك نقد محكم للدكتور عبد الغفار مكاوي حين أعاد ترجمة قصيدة جوته إلى
العربية، ودارت بينهما معركة قصيرة حول هذه الترجمة التي اتهمها شاكر
بالركاكة والسقم.
ثم دارت معركة أخرى بينه وبين الباحث العراقي الدكتور
علي جواد الطاهر حول تحقيقه كتاب "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي،
وتولد عن ذلك كتابه "برنامج طبقات فحول الشعراء".
تحقيق كتب التراث يعد
شاكر على رأس قائمة محققي التراث العربي، وأطلق عليه العقاد المحقق
الفنان، وإنجازاته في هذا المجال كثيرة، وهي عنوان على الدقة والإتقان، ومن
أشهر الكتب التي حققها: تفسير الطبري (16 جزءا)، طبقات فحول الشعراء
(مجلدان)، تهذيب الآثار للطبري (6 مجلدات).. وشاكر لا يحب أن يوصف بأنه
محقق لنصوص التراث العربي، وإنما يحب أن يوصف بأنه قارئ وشارح لها، وهو
يكتب على أغلفة الكتب التي يقوم بتحقيقها عبارة: "قرأه وشرحه" وهذه العبارة
كما يقول الدكتور محمود الربيعي "هي الحد الفاصل بين طبيعة عمله وطبيعة
عمل غيره من شيوخ المحققين، إنه يوجه النص ويبين معناه بنوع من التوجيه أو
القراءة التي تجعله محررا؛ لأنها قراءة ترفدها خبرة نوعية عميقة بطريقة
الكتابة العربية، وهو إذا مال بالقراءة ناحية معينة أتى شرحه مقاربا، وضبطه
مقنعا، وأفق فهمه واسعا، فخلع على النص بعض نفسه وأصبح كأنه صاحبه
ومبدعه".
صاحب رسالة لم يكن شاكر في
يوم من الأيام موظفا يمد يده نهاية كل شهر إلى مرتب ينتظره فتكون للحكومة
كلمة نافذة في رزقه ومكانته، بل انقطع لعلمه وفكره ومكتبته وبحثه ودرسه
وزملائه وتلاميذه كالراهب الذي انقطع للعبادة في صومعته.
وعاش على أقل
القليل يكفيه ويسد حاجته، ومرت عليه سنوات عجاف لكنه لم ينحن أو يميل على
الرغم من أن بيته كان مفتوحا لتلاميذه وأصدقائه وعارفي فضله.
ولم يكن
له من مورد سوى عائده من كتبه التي كان يقوم بتحقيقها، وكان اسمه على صدرها
يضمن لها النجاح والرواج، ولم يكن يأخذ شيئا على مقالاته التي يكتبها،
فأعاد لمجلة العربي الكويتية سنة 1982م مائة وخمسين دولارا نظير مقالة
كتبها ردا على الكاتب اليمني عبد العزيز المقالح حول طه حسين، ورفض أن
يتسلم من دار الهلال مكافأته عن تأليفه كتابه المهم "رسالة في الطريق إلى
ثقافتنا".
ولأنه كان يشعر أنه صاحب رسالة فإنه كان ينتفض حين يرى
انتهاك حرمة من حرمات اللغة العربية فيقف مدافعا عنها بكل ما يملك من أدوات
علمية وفكرية، تجعل الخصم يسلم بما يقول أو يلوي هاربا. ومعاركه كلها جمعت
في كتب وصارت وثائق في تاريخنا الفكري الحديث، كتبها هو من موقع المدافع
والحارس لثقافة الأمة، ولولا خصومه لما ظهرت معظم مؤلفاته؛ لأنها كانت
استجابة لتحديات عظيمة، وهي تظهر عظمة شاكر؛ لأنه لم يحتشد لها مثلما يحتشد
المؤلفون عند تأليف كتبهم وإنما دخلها كارها مستندا إلى ثقافة واسعة وعلم
غزير، وفكر ثاقب وروح وثابة، فأتى بالعجب العجاب.
وفي أخريات عمره رد
له بعض الاعتبار، فنال جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 1981م، ثم
جائزة الملك فيصل في الأدب العربي عام 1984م، وفي أثناء ذلك اختير عضوا في
مجمع اللغة العربية بدمشق، ثم بالقاهرة.
وبعد رحلة حياة عريضة رحل أبو
فهر شيخ العربية وإمام المحققين في الساعة الخامسة من عصر الخميس الموافق 3
من ربيع الآخر 1418هـ= 6 من أغسطس 1997م) ولبى نداء ربه.. فسلام عليك أبا
فهر.
